لا يجوز محاكمة الفكر: هل التكفير حرية تعبير؟:
«إننا بصدد آراء ضاربة في عمق التاريخ الإسلامي ولا تزال قيد البحث والدراسة، وتدور في فلك حرية الرأي و الفكر. وتبعًا للدستور الكويتي، لا يجوز محاكمة الفكر والتعبير». هذا ما جاء في حكم محكمة الاستئناف الكويتية الصادر ببراءة الشيخ الدكتور عثمان الخميس، في تهمة ازدراء المذهب الشيعي وشق الوحدة الوطنية. فما الحد الفاصل بين البحث العلمي و الازدراء؟ و التكفير وحرية التعبير؟
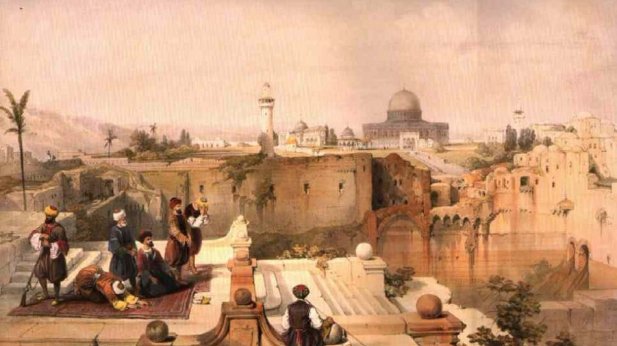 لوحة «David Roberts»
لوحة «David Roberts»
يعرَّف التكفير باعتباره «إطلاق حكم على ممارسة أو فكرة بأنها خارج حدود دين أو معتقد ما، وبالتالي الحكم على صاحبها بالخروج من هذا الدين أو المعتقد».
الكُفْر بالإسلام، بحسب دار الإفتاء المصرية، هو «إنكار ما عُلم ضرورةً أنه من دين سيدنا محمد-صلى الله عليه وسلم، كإنكار وجود الصانع، ونبوته عليه الصلاة والسلام، وحرمة الزنا ونحو ذلك». وحكم الوصف بالكفر كما تقول الفتوى «دائر بين حكمين: أحدهما التحريم، وذلك إذا كان مَن يوصف بالكفر مسلمًا باقيًا على إسلامه، ولم يقم الدليل على كفره. ثانيهما الوجوب، إذا كان وصف الكفر صادرًا ممن هو أهل له من المفتين والقضاة، وكان مَن وُصف به مستحقًّا له ممن توافر فيه شروط الكفر».
أي أن الدين الإسلامي، في نظر دار الافتاء، يقصُر حق التكفير على المفتين والقضاة دون غيرهم من عامة الناس، مع عدم التسرع بتكفير المسلم وإنزال الحكم عليه إلا بعد التثبُّت من كفره.
يقول المحامي الكويتي علي العريان: «لو أردنا أن نتحدث على مستوى نظري أكثر، ولو أردنا أن نجرد فكرة التكفير لنُرجعها إلى مفهومها العام، فإننا نرى أنها فكرة لازمة لكل أيدولوجيا ومدرسة فكرية وعقائدية ودين ومذهب وحزب وجماعة».
اقرأ أيضًا: هكذا وجد العلماء الله في مخ الإنسان
أما الكاتب والباحث المصري عمرو عزت فيقول إن مفهوم وممارسة التكفير في سياقها التاريخي والفقهي تستدعي مفاهيم أخرى ضرورية، هي «الجماعة المسلمة» والسلطة المعبرة عن هذه الجماعة أو التي تحاول أن تكون معبرة عنها، وكذلك «حدود الاعتقاد الإسلامي المفروضة من قِبل هذه السلطة».
الممارسة التاريخية للتكفير وما يترتب عليه قائمة على أن الجماعة المسلمة جماعة موحدة، في رأي عزت، وهناك سلطة معبرة عنها، وهذه السلطة تمارس سيادتها على حياة المسلمين الدينية وكذلك على حياة غير المسلمين، وتتبنى حدودًا للاعتقاد الإسلامي، ومن يخرج عليها تعلن خروجه عن الجماعة المسلمة، وسلطتها تتضمن التعامل مع من يخرج بالاستتابة أو القتل، مثلما هو مشهور في أحكام الفقه.
الشعراوي يشرح أسباب عقوبة المرتد عن الإسلام
يوضح علي العريان أن «هناك آثارًا فردية للتكفير في الإسلام، فالفقه الشيعي مثلًا يعتبر الكافر غير الكتابي نجس العين، فلو لمسه مسلم لزمه أن يتطهر قبل أداء الصلوات. هذا الأثر فردي لا يضر بالآخر، نعم قد يجرح مشاعره لو علم به، إلا أننا لو افترضنا عدم علمه فهو يكون ضمن دائرة الحرية الفردية للمسلم، تمامًا كالكراهية العنصرية التي تبقى حبيسةً في صدر الشخص العنصري دون أن تنعكس على سلوكه الخارجي، فهي ليست إلا حرية شخصية لا يجوز أن نحاسبه عليها».
وقد حدد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حرية التعبير في المادة 19، التي تنص على أن «لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقِّيها ونقلها إلى الآخرين، بأي وسيلة ودونما اعتبار للحدود».
حدث هذا مع المفكر المصري نصر حامد أبو زيد، الذي فُرِّق عن زوجته بحكم قضائي بعد زوبعة أثارها الإسلاميون في تسعينيات القرن الماضي، بسبب كتاباته في الفكر الإسلامي، التي اتُّهم بسببها بالارتداد عن الإسلام.
حدث كذلك مع الروائي سلمان رشدي، الذي أصدر آية الله الخميني فتوى بقتله، ورصد جائزة قدرها ستمئة ألف دولار من أجل ذلك، بسبب روايته «آيات شيطانية» التي تتعرض للنبي محمد وزوجاته، وحتى مترجموها أيضًا تعرَّضوا للخطر، فقُتل مترجم الرواية إلى اليابانية طعنًا عام 1991.
قد يهمك أيضًا: الإسلام الوسطي مجرد أسطورة: الشعرواي نموذجًا
يقول علي العريان إن هناك آثارًا إجرامية تمتد إلى الآخر، يختصرها الفقهاء الإسلاميون بعبارة «مستباح الدم والمال والعِرض»، فاستباحة دم الكافر أي مصادرة حقه في الحياة، واستباحة ماله أي مصادرة حقه في الملكية الخاصة، واستباحة عِرضه هي إجازة سَبْيِ نسائه بعد تحقيق الانتصارات وفتح بلدان الكفر.
يذكر العريان أن الطوائف الإسلامية تتفق على ذلك: فأحد كبار مراجع الطائفة الشيعية إبان حياته وزعيم الحوزة العلمية، آية الله السيد أبو القاسم الخوئي، يقول في كتابه «منهاج الصالحين» إن هناك طوائف ثلاثة يجب قتالها، أولاها «الكفار المشركون غير أهل الكتاب، فإنه يجب دعوتهم إلى كلمة التوحيد والإسلام، فإن قبلوا وإلا وجب قتالهم وجهادهم إلى أن يسلموا أو يُقتَلوا وتطهر الأرض من لوث وجودهم، ولا خلاف في ذلك بين المسلمين قاطبة».
يذكر عمرو عزت أن «ممارسة التكفير مناقضة تمامًا للتصور الديموقراطي أو الحقوقي الحديث، خصوصًا أن معظم الدول العربية الإسلامية لا تزال في سياساتها تتمسك ببواقي أو أشكال من الإطار التاريخي لممارسة التكفير، فتتمسك بتصور موحد مفترض للجماعة المسلمة، مناقض للواقع غالبًا، وغير مسموح بالتنوع داخل الإسلام إلى حدود معينة، فهناك سيادة دينية للمسلمين على غيرهم بالدساتير والقوانين والممارسات، وهذه السيادة تسوِّغ للسلطات مساءلة وعقاب من يخرج اعتقاديًّا عن الجماعة المسلمة المفترضة. في هذه الحالة، ممارسة التكفير أو إطلاق أحكام الكفر تتضمن تهديدًا كبيرًا».
من جانب آخر، هناك تيارات إسلامية مناوئة للسلطات في هذه الدول، وتحاول طلب ممارسة السلطة باسم سيادة للمسلمين، وتطلق أحكام الكفر على مسؤولين في الدولة أو مفكرين وفنانين وعلماء دين، وهي هنا تستلهم تاريخ الجماعة المسلمة قبل وصولها إلى التمكين، مع تأويلات واجتهادات لتناسب ممارسة سلطتها المفترضة وإهدارها الدماء والتصرف بناءً على ذلك، وبالتالي فهذه الممارسة أيضًا لا علاقة لها بأي سياق ديموقراطي أو حقوقي، وتتضمن تحريضًا وتهديدًا كبيرًا.
بحسب عزت، فالسجال بين السلطات والتيارات الإسلامية المناوئة هنا «يدور على أرضية بعيدة تمامًا عن أي تأسيس حقوقي لحرية الدين وحرية التعبير».
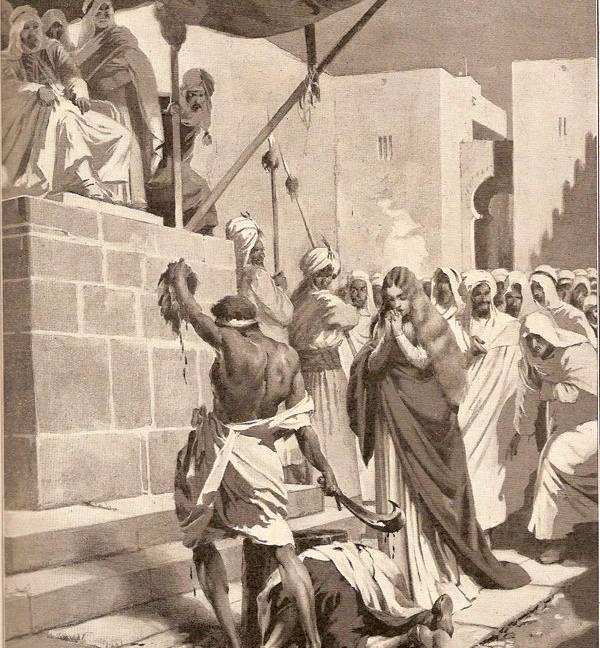 لوحة من رسم «Josep Segrelles»
لوحة من رسم «Josep Segrelles»
بالتالي، السؤال ذاته حول التكفير قد يُطرح بأبعاد أخرى: فهل الاعتقاد بكفر الآخر جزء من «حرية الاعتقاد»؟ وهل تعليم النشء أن من البشر من هو كافر ومن هو مؤمن من «حرية التعليم»؟ وهل وصف بعض الفئات أو الأفراد بالكفر في الصحف ووسائل الإعلام من «حرية الصحافة والإعلام»؟
يضيف العريان: «لئِن كان أصل تلك الحريات مما يقرره القانون الطبيعي ومن حقوق وحريات الإنسان الأساسية، فإنها ليست حريات مطلقة بل عليها قيود، وقد أحالت بعض الدساتير، ومنها الدستور الكويتي، إلى المشرِّع العادي لوضع قوانين كفيلة بتنظيم تلك الحريات وضبطها».
هذا ما فعلته الكويت عبر إقرارها قانون الوحدة الوطنية، أما الإمارات فقد أقرت قانونًا بشأن مكافحة التمييز والكراهية، نصَّ بشكل صريح على عدم جواز الاحتجاج بحرية التعبير في مسألة ازدراء الأديان والإساءة إليها، رغم أنه خص الأديان السماوية فقط في هذه الحماية، ورغم أن مثل هذه القوانين قد تُستخدم في تقييد حرية التعبير، فتكون سيفًا مسلطًا على رقاب البحوث العلمية والنقد، لكنه سيف ذو حدين.
قد يعجبك أيضًا: لماذا يعود بعض الملحدين إلى الدين؟
يضرب عمرو عزت مثلًا بالحال في الدول الديموقراطية الغربية مثلًا، فلا توجد جماعة مسلمة موحدة ذات سيادة على غيرها، بل جماعات أو تجمعات مسلمة متعددة، وحريتهم كلهم مكفولة، ولا سلطة لأي جماعة على غيرها، وهي لا تمارس سيادة على حياة المنتمين إليها إلا بالتوجيه والتعليم الديني وتنظيم علاقات قائمة على التراضي، والدولة تحمي حرية هذه التجمعات وتكبح أي محاولات لممارسة السلطة أو العدوان تجاه جماعة أخرى أو فرد آخر.
في الدول الديموقراطية الغربية كذلك، من حق وحرية المواطن أن يكون مؤمنًا أو كافرًا دون تبعات قانونية أو مضايقات أو تقييد لحقوق، وبالتالي فإن إطلاق أحكام الكفر والتكفير من طرف إلى طرف يكون مجرد شأن فكري وعقدي وتنظيمي، كأن يحافظ تجمع من المسلمين على منظومة معينة لأفكاره ويشير إلى أن أفكار أخرى خارجة عن هذا النطاق، ومن يعتقدها فهو خارج عن الجماعة أو التجمع، بدون محاولة ممارسة سلطة عليه، وهنا «يصبح التكفير جزءًا من حرية الدين وحرية التعبير».
أما في سياق العلاقة بين أهل الأديان المختلفة والإشارة إلى بعضهم بالكفر، فهذا من أصول معظم العقائد في نظرتها إلى بعضها بعضًا، والتعبير عن ذلك جزء من حرية الدين وحرية التعبير، ما لم يتضمن تحريضًا على التمييز في الحقوق أو عنفًا.
الإشكالية هنا في بلادنا العربية الإسلامية بسبب سياق السياسات الدينية، الذي لا يؤسس أصلًا لحرية الدين والمعتقَد ولا لحرية التنوع الديني، بل يؤسس في المقابل لتسلطات دينية، فممارسة التكفير من قِبل بعض المجموعات المسلمة في هذا السياق تكون إشكالية، حتى لو كانت لا تريد ممارسة السلطة أو العدوان على آخرين.
إذا كانت تلك المجموعة التي تطلق حكم التكفير تريد فقط حماية حدودها وأفكارها، ولا تريد ولا تشير ولا تلمِّح إلى محاولة ممارسة تسلط على غيرها أو عدوان عليه، أو التوجه إلى الدولة لممارسة هذا التسلط أو العدوان، فهذا يمكن أن يندرج تحت حرية التعبير في بعض الحالات، لكن في المقابل هناك احتمالات لتعرض الشخص أو المجموعة الموصومة بالتكفير للعدوان من آخرين، أو للانتقاص من حقوقهم المدنية، أو لاستعداء السلطات أو المجتمع عليهم، أو تهديدهم بشكل غير مباشر.
لا يمكن التعامل مع ذلك إلا بإصلاح منظومة الحقوق وسياسات الدولة تجاه الدين، وحتى ذلك الوقت يتطلب الحكم على وقائع التكفير وفق كل حالة وسياقها وكيفية مواجهة مخاطرها. ويبقى السؤال: كيف تكفل الدول التكفير كجزء من حرية التعبير، بينما لا تكفل حرية الكفر نفسها؟
«إننا بصدد آراء ضاربة في عمق التاريخ الإسلامي ولا تزال قيد البحث والدراسة، وتدور في فلك حرية الرأي و الفكر. وتبعًا للدستور الكويتي، لا يجوز محاكمة الفكر والتعبير». هذا ما جاء في حكم محكمة الاستئناف الكويتية الصادر ببراءة الشيخ الدكتور عثمان الخميس، في تهمة ازدراء المذهب الشيعي وشق الوحدة الوطنية. فما الحد الفاصل بين البحث العلمي و الازدراء؟ و التكفير وحرية التعبير؟
ما هو التكفير؟
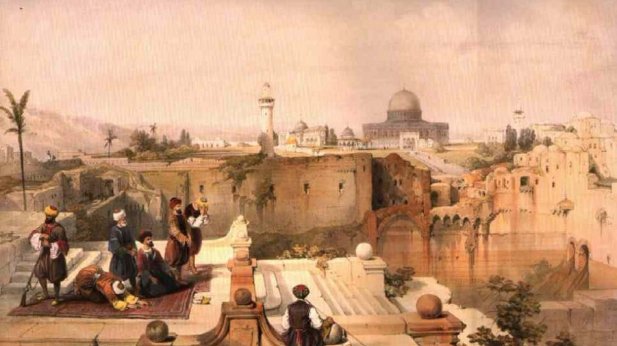
يعرَّف التكفير باعتباره «إطلاق حكم على ممارسة أو فكرة بأنها خارج حدود دين أو معتقد ما، وبالتالي الحكم على صاحبها بالخروج من هذا الدين أو المعتقد».
الكُفْر بالإسلام، بحسب دار الإفتاء المصرية، هو «إنكار ما عُلم ضرورةً أنه من دين سيدنا محمد-صلى الله عليه وسلم، كإنكار وجود الصانع، ونبوته عليه الصلاة والسلام، وحرمة الزنا ونحو ذلك». وحكم الوصف بالكفر كما تقول الفتوى «دائر بين حكمين: أحدهما التحريم، وذلك إذا كان مَن يوصف بالكفر مسلمًا باقيًا على إسلامه، ولم يقم الدليل على كفره. ثانيهما الوجوب، إذا كان وصف الكفر صادرًا ممن هو أهل له من المفتين والقضاة، وكان مَن وُصف به مستحقًّا له ممن توافر فيه شروط الكفر».
أي أن الدين الإسلامي، في نظر دار الافتاء، يقصُر حق التكفير على المفتين والقضاة دون غيرهم من عامة الناس، مع عدم التسرع بتكفير المسلم وإنزال الحكم عليه إلا بعد التثبُّت من كفره.
يقول المحامي الكويتي علي العريان: «لو أردنا أن نتحدث على مستوى نظري أكثر، ولو أردنا أن نجرد فكرة التكفير لنُرجعها إلى مفهومها العام، فإننا نرى أنها فكرة لازمة لكل أيدولوجيا ومدرسة فكرية وعقائدية ودين ومذهب وحزب وجماعة».
تتبنى سلطة الجماعة المسلمة حدودًا للاعتقاد الإسلامي، ومن يخرج عنها تعلن خروجه عن الجماعة.يتابع العريان متحدثًا لـ«منشور»: «التكفير ليس سوى تحديدًا لدائرة ما هو إسلام وما ليس بإسلام، ومن هو مسلم ومن ليس بمسلم، نفس العملية يمارسها أتباع جميع الأيديولوجيات، فالشيوعي مثلًا له تعريف للشيوعية دون شك، يحدد نطاقها ودائرتها تحديدًا جامعًا لأفرادها مانعًا لأغيارها، وليس ذلك سوى ما يعرِّفه الإسلامي ببحث الإسلام والكفر. حين يقف الشيوعي ليقول إن فلانًا خارج عن دائرة الشيوعية لأنه غير ملتزم بضرورياتها العقائدية وممارساتها الأساسية، فإنه لا يختلف عن الإسلامي الذي يمارس التكفير، ولو وقفت المسألة عند هذا الحد فهي دون شك من حرية الرأي والتعبير والبحث العلمي، وإجمالًا، فهي من الحريات الفكرية المشروعة».
اقرأ أيضًا: هكذا وجد العلماء الله في مخ الإنسان
أما الكاتب والباحث المصري عمرو عزت فيقول إن مفهوم وممارسة التكفير في سياقها التاريخي والفقهي تستدعي مفاهيم أخرى ضرورية، هي «الجماعة المسلمة» والسلطة المعبرة عن هذه الجماعة أو التي تحاول أن تكون معبرة عنها، وكذلك «حدود الاعتقاد الإسلامي المفروضة من قِبل هذه السلطة».
الممارسة التاريخية للتكفير وما يترتب عليه قائمة على أن الجماعة المسلمة جماعة موحدة، في رأي عزت، وهناك سلطة معبرة عنها، وهذه السلطة تمارس سيادتها على حياة المسلمين الدينية وكذلك على حياة غير المسلمين، وتتبنى حدودًا للاعتقاد الإسلامي، ومن يخرج عليها تعلن خروجه عن الجماعة المسلمة، وسلطتها تتضمن التعامل مع من يخرج بالاستتابة أو القتل، مثلما هو مشهور في أحكام الفقه.
لماذا يعتبر التكفير خطرًا في بلاد المسلمين؟
الشعراوي يشرح أسباب عقوبة المرتد عن الإسلام
يوضح علي العريان أن «هناك آثارًا فردية للتكفير في الإسلام، فالفقه الشيعي مثلًا يعتبر الكافر غير الكتابي نجس العين، فلو لمسه مسلم لزمه أن يتطهر قبل أداء الصلوات. هذا الأثر فردي لا يضر بالآخر، نعم قد يجرح مشاعره لو علم به، إلا أننا لو افترضنا عدم علمه فهو يكون ضمن دائرة الحرية الفردية للمسلم، تمامًا كالكراهية العنصرية التي تبقى حبيسةً في صدر الشخص العنصري دون أن تنعكس على سلوكه الخارجي، فهي ليست إلا حرية شخصية لا يجوز أن نحاسبه عليها».
وقد حدد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حرية التعبير في المادة 19، التي تنص على أن «لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقِّيها ونقلها إلى الآخرين، بأي وسيلة ودونما اعتبار للحدود».
يختصر الفقهاء بعبارة «مستباح الدم والمال والعِرض» آثارًا إجرامية، منها مصادرة الحياة والملكية وسبي النساء.نظريًّا، يعتبر تكفير جماعة أو فرد ضمن حرية البحث الديني والنقد والتعبير، وتندرج تحت إبداء صاحب التخصص رأيه، لكن الإشكالية تكمُن في خطورة التكفير وما يليه من أحكام تقام على المكفَّر.
حدث هذا مع المفكر المصري نصر حامد أبو زيد، الذي فُرِّق عن زوجته بحكم قضائي بعد زوبعة أثارها الإسلاميون في تسعينيات القرن الماضي، بسبب كتاباته في الفكر الإسلامي، التي اتُّهم بسببها بالارتداد عن الإسلام.
حدث كذلك مع الروائي سلمان رشدي، الذي أصدر آية الله الخميني فتوى بقتله، ورصد جائزة قدرها ستمئة ألف دولار من أجل ذلك، بسبب روايته «آيات شيطانية» التي تتعرض للنبي محمد وزوجاته، وحتى مترجموها أيضًا تعرَّضوا للخطر، فقُتل مترجم الرواية إلى اليابانية طعنًا عام 1991.
قد يهمك أيضًا: الإسلام الوسطي مجرد أسطورة: الشعرواي نموذجًا
يقول علي العريان إن هناك آثارًا إجرامية تمتد إلى الآخر، يختصرها الفقهاء الإسلاميون بعبارة «مستباح الدم والمال والعِرض»، فاستباحة دم الكافر أي مصادرة حقه في الحياة، واستباحة ماله أي مصادرة حقه في الملكية الخاصة، واستباحة عِرضه هي إجازة سَبْيِ نسائه بعد تحقيق الانتصارات وفتح بلدان الكفر.
يذكر العريان أن الطوائف الإسلامية تتفق على ذلك: فأحد كبار مراجع الطائفة الشيعية إبان حياته وزعيم الحوزة العلمية، آية الله السيد أبو القاسم الخوئي، يقول في كتابه «منهاج الصالحين» إن هناك طوائف ثلاثة يجب قتالها، أولاها «الكفار المشركون غير أهل الكتاب، فإنه يجب دعوتهم إلى كلمة التوحيد والإسلام، فإن قبلوا وإلا وجب قتالهم وجهادهم إلى أن يسلموا أو يُقتَلوا وتطهر الأرض من لوث وجودهم، ولا خلاف في ذلك بين المسلمين قاطبة».
يذكر عمرو عزت أن «ممارسة التكفير مناقضة تمامًا للتصور الديموقراطي أو الحقوقي الحديث، خصوصًا أن معظم الدول العربية الإسلامية لا تزال في سياساتها تتمسك ببواقي أو أشكال من الإطار التاريخي لممارسة التكفير، فتتمسك بتصور موحد مفترض للجماعة المسلمة، مناقض للواقع غالبًا، وغير مسموح بالتنوع داخل الإسلام إلى حدود معينة، فهناك سيادة دينية للمسلمين على غيرهم بالدساتير والقوانين والممارسات، وهذه السيادة تسوِّغ للسلطات مساءلة وعقاب من يخرج اعتقاديًّا عن الجماعة المسلمة المفترضة. في هذه الحالة، ممارسة التكفير أو إطلاق أحكام الكفر تتضمن تهديدًا كبيرًا».
من جانب آخر، هناك تيارات إسلامية مناوئة للسلطات في هذه الدول، وتحاول طلب ممارسة السلطة باسم سيادة للمسلمين، وتطلق أحكام الكفر على مسؤولين في الدولة أو مفكرين وفنانين وعلماء دين، وهي هنا تستلهم تاريخ الجماعة المسلمة قبل وصولها إلى التمكين، مع تأويلات واجتهادات لتناسب ممارسة سلطتها المفترضة وإهدارها الدماء والتصرف بناءً على ذلك، وبالتالي فهذه الممارسة أيضًا لا علاقة لها بأي سياق ديموقراطي أو حقوقي، وتتضمن تحريضًا وتهديدًا كبيرًا.
بحسب عزت، فالسجال بين السلطات والتيارات الإسلامية المناوئة هنا «يدور على أرضية بعيدة تمامًا عن أي تأسيس حقوقي لحرية الدين وحرية التعبير».
هل حلَّت القوانين معضلة التكفير؟
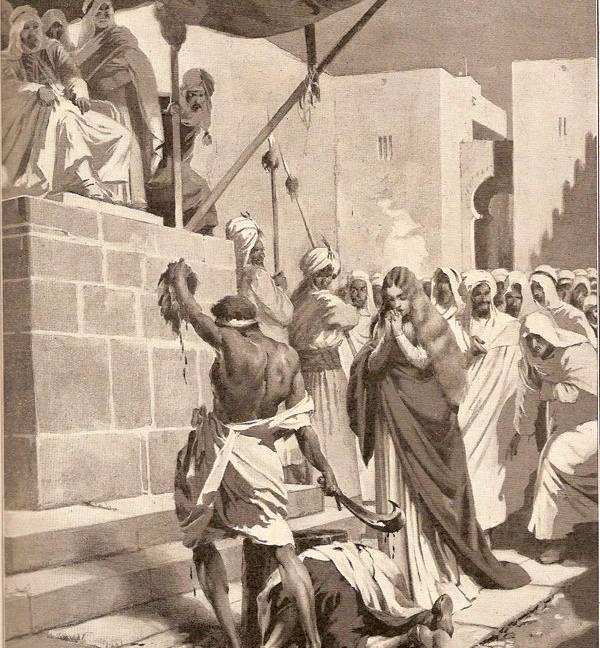
قد تُستَخدم قوانين الكويت للوحدة الوطنية وقانون الإمارات لمكافحة التمييز والكراهية في تقييد حرية التعبير، فهي سيف ذو حدين.في رأي علي العريان، ينبغي القول بأن حرية الرأي والتعبير من الحريات الأساسية والحقوق الطبيعية اللصيقة بشخصية الإنسان، وهي من بين الحريات الفكرية، التي تتضمن حرية الرأي وحرية الاعتقاد وحرية التعليم وحرية الصحافة.
بالتالي، السؤال ذاته حول التكفير قد يُطرح بأبعاد أخرى: فهل الاعتقاد بكفر الآخر جزء من «حرية الاعتقاد»؟ وهل تعليم النشء أن من البشر من هو كافر ومن هو مؤمن من «حرية التعليم»؟ وهل وصف بعض الفئات أو الأفراد بالكفر في الصحف ووسائل الإعلام من «حرية الصحافة والإعلام»؟
يضيف العريان: «لئِن كان أصل تلك الحريات مما يقرره القانون الطبيعي ومن حقوق وحريات الإنسان الأساسية، فإنها ليست حريات مطلقة بل عليها قيود، وقد أحالت بعض الدساتير، ومنها الدستور الكويتي، إلى المشرِّع العادي لوضع قوانين كفيلة بتنظيم تلك الحريات وضبطها».
هذا ما فعلته الكويت عبر إقرارها قانون الوحدة الوطنية، أما الإمارات فقد أقرت قانونًا بشأن مكافحة التمييز والكراهية، نصَّ بشكل صريح على عدم جواز الاحتجاج بحرية التعبير في مسألة ازدراء الأديان والإساءة إليها، رغم أنه خص الأديان السماوية فقط في هذه الحماية، ورغم أن مثل هذه القوانين قد تُستخدم في تقييد حرية التعبير، فتكون سيفًا مسلطًا على رقاب البحوث العلمية والنقد، لكنه سيف ذو حدين.
قد يعجبك أيضًا: لماذا يعود بعض الملحدين إلى الدين؟
يضرب عمرو عزت مثلًا بالحال في الدول الديموقراطية الغربية مثلًا، فلا توجد جماعة مسلمة موحدة ذات سيادة على غيرها، بل جماعات أو تجمعات مسلمة متعددة، وحريتهم كلهم مكفولة، ولا سلطة لأي جماعة على غيرها، وهي لا تمارس سيادة على حياة المنتمين إليها إلا بالتوجيه والتعليم الديني وتنظيم علاقات قائمة على التراضي، والدولة تحمي حرية هذه التجمعات وتكبح أي محاولات لممارسة السلطة أو العدوان تجاه جماعة أخرى أو فرد آخر.
في الدول الديموقراطية الغربية كذلك، من حق وحرية المواطن أن يكون مؤمنًا أو كافرًا دون تبعات قانونية أو مضايقات أو تقييد لحقوق، وبالتالي فإن إطلاق أحكام الكفر والتكفير من طرف إلى طرف يكون مجرد شأن فكري وعقدي وتنظيمي، كأن يحافظ تجمع من المسلمين على منظومة معينة لأفكاره ويشير إلى أن أفكار أخرى خارجة عن هذا النطاق، ومن يعتقدها فهو خارج عن الجماعة أو التجمع، بدون محاولة ممارسة سلطة عليه، وهنا «يصبح التكفير جزءًا من حرية الدين وحرية التعبير».
أما في سياق العلاقة بين أهل الأديان المختلفة والإشارة إلى بعضهم بالكفر، فهذا من أصول معظم العقائد في نظرتها إلى بعضها بعضًا، والتعبير عن ذلك جزء من حرية الدين وحرية التعبير، ما لم يتضمن تحريضًا على التمييز في الحقوق أو عنفًا.
الإشكالية هنا في بلادنا العربية الإسلامية بسبب سياق السياسات الدينية، الذي لا يؤسس أصلًا لحرية الدين والمعتقَد ولا لحرية التنوع الديني، بل يؤسس في المقابل لتسلطات دينية، فممارسة التكفير من قِبل بعض المجموعات المسلمة في هذا السياق تكون إشكالية، حتى لو كانت لا تريد ممارسة السلطة أو العدوان على آخرين.
إذا كانت تلك المجموعة التي تطلق حكم التكفير تريد فقط حماية حدودها وأفكارها، ولا تريد ولا تشير ولا تلمِّح إلى محاولة ممارسة تسلط على غيرها أو عدوان عليه، أو التوجه إلى الدولة لممارسة هذا التسلط أو العدوان، فهذا يمكن أن يندرج تحت حرية التعبير في بعض الحالات، لكن في المقابل هناك احتمالات لتعرض الشخص أو المجموعة الموصومة بالتكفير للعدوان من آخرين، أو للانتقاص من حقوقهم المدنية، أو لاستعداء السلطات أو المجتمع عليهم، أو تهديدهم بشكل غير مباشر.
لا يمكن التعامل مع ذلك إلا بإصلاح منظومة الحقوق وسياسات الدولة تجاه الدين، وحتى ذلك الوقت يتطلب الحكم على وقائع التكفير وفق كل حالة وسياقها وكيفية مواجهة مخاطرها. ويبقى السؤال: كيف تكفل الدول التكفير كجزء من حرية التعبير، بينما لا تكفل حرية الكفر نفسها؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق